بالنتيجة جرت الانتخابات على الرغم ان هناك استجابة لقرار المقاطعة لان لا توجد هناك حد فاصل للقبول او الرفض، لكن ربما للوضع الإقليمي وتصاعد الخطاب الطائفي أدوار كبيرة في زيادة النسبة التي وصلت الى 56%، وفازت فيها قائمة ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمرتبة الأولى ائتلاف الإعمار والتنمية الذي حصل وفقا لنتائج أولية على 46 مقعدًا متصدرًا الانتخابات العامة في أغلب ثمان محافظات من الوسط والجنوب البصرة، كربلاء، النجف، القادسية، بابل، واسط، ذي قار، المثنى فيما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة السيد نوري المالكي على 29 مقعدًا مستندًا إلى عدد من الشخصيات التنفيذية وشيوخ العشائر في عدد من المحافظات الوسطى الجنوبية.
وحصل تحالف تقدّم على 28 مقعدًا متصدرًا المحافظات الغربية (الأنبار، بغداد، نينوى، صلاح الدين، كركوك) والذي يُعد الكتلة السنية الأولى من حيث عدد المقاعد، فيما حصلت حركة صادقون او العصائب على 27 مقعدًا مستندًا إلى عدد من الشخصيات التنفيذية وشيوخ العشائر في عدد من المحافظات الوسطى الجنوبية، وتمثل القوة الثالثة ضمن التحالفات الشيعية الكبرى، وفازت منظمة بدر بزعامة السيد هادي العامري بـ 18 مقعدًا مع نفوذ واضح في ميسان وواسط والمثنى.
اما تيار الحكمة بزعامة السيد عمار الحكيم فقد حصل 18 مقعدًا مستندًا إلى عدد من الشخصيات التنفيذية وشيوخ العشائر في عدد من المحافظات الوسطى الجنوبية، في حين حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) بزعامة السيد مسعود برزاني على 18 مقعدًا متصدراً محافظات أربيل ودهوك وله تمثيل واسع في نينوى، ويُعد الحزب الكردي الأكبر في الإقليم.
وحصل تحالف واسط أجمل بزعامة محافظ واسط السابق السيد محمد المياحي حصل على 5 مقاعد، وحصل تحالف عزم العراق بزعامة السيد مثنى السامرائي على 15 مقعدًا، متمركزًا في نينوى وصلاح الدين والأنبار، ويشكل ثاني أكبر الكتل السنية تمثيلًا، وفاز تحالف سيادة بزعامة السيد خميس الخنجر على 9 مقاعد وله تمثيل في بغداد، وصلاح الدين، ونينوى، فيما حصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) بزعامة قوبال طالباني على 14 مقاعد متمركزًا في السليمانية، وكركوك، ويحتفظ بمكانته كثاني أكبر حزب كردي.
وحصل تحالف الأساس الوطني بزعامة محسن المندلاوي 8 مقاعد. وفازت حركة حقوق بزعامة السيد حسين مؤنس بـ 6 محافظة على تمثيل متوزع في سبع محافظات أبرزها بغداد والبصرة وذي قار وميسان. وحصلت حركة اشراقة كانون على المقاعد 8 وهي من الحركات الناشئة غير التقليدية، وحصد تحالف خدمات بزعامة السيد شبل الزيدي 5 مقاعد، وحصد تيار الجيل الجديد بزعامة المعتقل شسوار عبد الواحد 6 مقاعد، متمركزًا في السليمانية وأربيل، وحصل تحالف ابشر يا عراق بزعامة الشيخ همام حمودي على 4 مقاعد فقط، موزعة على محافظات الجنوب (البصرة، ذي قار، النجف، ميسان).
وفي قراءة نسبة المشاركة وحجوم الكتل الانتخابية يتضح لنا الاتي:
1. الأرقام الرسمية تشير إلى مشاركة تتجاوز 55% (حوالي 56.1% في بعض المصادر) هذا الرقم يبدو أعلى من المتوقع لدى أنصار المقاطعة، لكن التحليل النوعي يُظهر تفاوتًا جغرافيًا عميقًا: انخفاض ملحوظ في مناطق نفوذ الصدريين (مثل بعض أحياء بغداد) مقابل مشاركة أعلى في دوائر مؤسساتية (قوات أمنية ودوائر إدارية).
اما عن شرعية نسبية المشاركة بهذا المستوى فهي قد تمنح نتائج الانتخابات درجة من الشرعية، لكنها لا تُعالج جذور الشرعية الاجتماعية (ثقة المواطنين بالمؤسسات)، كما يتضح ان تحيّز تركيب الناخبين من حيث نسب المقاطعة والخروج من سجلات انتخابية (أو بيع بطاقات) تُحوِّل المشهد الانتخابي إلى “نخبةٍ مُشاركة” أكثر ممّن يمثلون الطبقات المؤسسة أو الشبكات المموِّلة، هذا يفضي إلى تمثيلٍ لا يعكس بدقّة انقسامات الشارع.
2. جدليات القانون الانتخابي وتطبيقه اذ ان الإطار القانوني (نظام الدوائر/ الكوتا وما شابه) ظلّ محلّ نقد القوانين الجديدة أو المعدّلات التي طُبِّقت في الدورات الأخيرة تهدف ظاهريًا لتعزيز التمثيل المحلي، لكن في الواقع خلقت فرصًا لتحالفات ما قبل الاقتراع وتقسيم الموارد الانتخابية بطرق تفيد الكتل الكبيرة والمرشحين المدعومين بقوّة لوجستية ومالية، كما ان هناك نقاط فنية جديرة بالتحليل منها ان آلية احتساب الأصوات: قوانين احتساب المقاعد (بنظام القائمة المفتوحة/المقفل) تؤثر مباشرة في قدرة المستقلين على التنافس، تعدد الدوائر أصلاً ليس كافيًا إن لم تُصحَب بإصلاحات في التمويل واللوجستيات، اما من حيث توقيت الانتخابات وإجراءات التنفيذ: شكاوى حول توقيت التصويت والموارد (مثل مراكز اقتراع ونزاهة لوائح الناخبين) أثّرت في الإدراك العام للعدالة الإجرائية.
3. جدلية استعمال المال السياسي والقدرة التأثيرية والآثار فقد اشارت تقارير تقديرية تتحدث عن مبالغ ضخمة تُستثمر في الحملات (تجاوزت تقديرات غير رسمية مليارات الدولارات في الحملات والإعلانات والترغيب المباشر)، كما سجلت إجراءات ضبط (اعتقالات لقضايا تبييض أو تهريب بطاقات انتخابية) في أيام الحملة وما قبلها، هذا يبيّن أن المال السياسي لم يغب بل ازداد تأثيره عبر وسائل حديثة (إعلانات مكثفة، شبكات شراء أصوات، استهداف جماعات هشّة)، وهو ما يقود الى انعكاسات عملية تخص تشويه الحوافز البرلمانية اذ ان المرشح الذي يستثمر مبلغًا ضخمًا يحتاج إلى “استرداد” ما يولّد مناخًا فسادياً محتملًا بعد الفوز، وتعميق التفاوت بين المرشحين المدنيين والمستقلين يواجهون عجزًا تمويليًا حادًا مقارنة بالكتل المدعومة من أحزاب أو رجال أعمال، ما يجعل المنافسة غير متكافئة.
4. الدور العشائري فقد تغيّر الأدوار وليس الغياب فقد استمرت العشائر كقوة فاعلة، خصوصًا في المحافظات الجنوبية والغربية، لكن طبيعة الدور تغيّرت: من نفوذ تقليدي مطلق إلى قدرة على التكيّف مع آليات الانتخابات الحديثة (تجميع قوائم، تفاهمات مع مرشحين حزبيين، حشد لوجستي)، بعض التحليلات تسجّل أن العشيرة صارت “جسرًا” بين السياسة التقليدية والعملية الحزبية المعاصرة فالبعد الإيجابي قد توفر قنوات دعم وتنظيم في أماكن غابت فيها مؤسسات الدولة الفاعلة، اما البعد السلبي فتحويل الأصوات إلى سلعة تفاوضية وإضعاف السلوك الانتخابي القائم على البرامج (الولاء للعشيرة أولًا)، هذا يعيق بناء ثقافة سياسية مدنية ومؤسساتية.
وهنا يعرض التساؤل الاستنتاجي وهو لماذا خسرت الشخصيات المدنية والمستقلون؟ (عوامل مركّبة)، وقد تكون إجابة هذا التساؤل مرتبطة بعدد من العوامل منها: ضعف البنية التنظيمية والتنموية لتلك الشخصيات والتنظيمات فكثير من الشخصيات المدنية خرجت من حراك الشارع (تشرين 2019) لكن لم تتمكّن من تحويل ذلك الزخم إلى أحزاب مؤسسية قابلة للتحمّل (شبكات متبرعة، أقسام شبابية، قواعد محلية)، بالتالي كان تأثيرها في صناديق الاقتراع محدودًا، بالاضافة الى نقص التمويل والموارد فالمنافسة مع قوى مدعومة ماليًا ولوجستيًا (كتل سياسية، رجال أعمال، شبكات عائلية وعشائرية) غير متكافئة.
اما العنصر الثالث فيتمثل بانزلاق الخطاب وتأثير الأمن والضغط: في بعض المناطق لعبت مخاطر العنف أو الضغط الأمني دورًا في ردع الناخبين أو تغيير خياراتهم لصالح مرشحين أكثر قابلية للتعامل مع الفاعلين المسلّحين أو المؤسسات، وكذلك تحيّز قواعد التمثيل الانتخابي حسب قانون سانت ليغو تُجهض فرص المرشحين المستقلين بغياب مظاهر دعم مركزي وواضح.
ومما تقدم نستنتج ان العملية الانتخابية الأخيرة 2025 في العراق عبارة عن مفارقة بنيوية عميقة، فالنظام السياسي ينجح في تكرار العملية الانتخابية بوصفها طقسًا ديمقراطيًا، لكنه يفشل في تحويلها إلى آلية حقيقية لإعادة إنتاج الشرعية السياسية أو إعادة توزيع السلطة وفق منطق المواطنة، إن نسب المشاركة مهما بدت مرتفعة رسميًا، لا تخفي تحولات تركيب الجسم الانتخابي وتحوّل الانتخابات ذاتها إلى ساحة تنافس بين شبكات منظمة ماليًا وعشائريًا، مقابل غياب كتلة اجتماعية واسعة تعبّر عن إرادة الشارع خارج هذه البُنى التقليدية.
هذا الانحراف عن جوهر التمثيل الديمقراطي يضع العملية الانتخابية أمام تحديين متداخلين: أزمة الثقة وأزمة القابلية المؤسسية، فمن جهة تتآكل ثقة المواطنين بسبب شعور متنامٍ بأن الاقتراع لا يغيّر في طبيعة السلطة أو أولوياتها، ومن جهة أخرى تتكرر أنماط السلوك الانتخابي القائمة على النفوذ المالي والعشائري، ما يجعل نتائج الاقتراع انعكاسًا لموازين القوى لا لتفضيلات المواطنين.
ومع استمرار هذا المسار، يصبح البرلمان امتدادًا للتحالفات الاقتصادية والعشائرية أكثر من كونه تمثيلًا للمجتمع ولضمان تحول نوعي في العملية الديمقراطية، لا بد من الانتقال من إصلاحات شكلية إلى إصلاحات بنيوية، أبرزها: إعادة صياغة القانون الانتخابي بما يقلّص اختلالات التمثيل التي تخلقها آليات مثل سانت ليغو ويحمي فرص المستقلين وتقسيم عادل للفائز وإعادة النظر بتوزيع مقاعد الكوتة خصوصا بعد اقصاء عدد من النساء من الفوز رغم حصولهن عن أصوات تفوق بعض النساء الفائزات بثلاثة اضعاف وفي نفس الدائرة الانتخابية، وضرورة ضبط التمويل السياسي بشكل صارم عبر شفافية إلزامية وملاحقة قانونية لشبكات شراء الأصوات بعد المخالفات الكبيرة التي رصدتها عدد من المؤسسات، وإعادة بناء سجل الناخبين لمنع التلاعب وإعادة الاعتبار للمشاركة الطوعية لا التعبوية، وخلق بيئة آمنة سياسيًا تُحيّد الفاعلين المسلحين عن التأثير في إرادة الناخبين، وإعادة تعريف المنافسة السياسية، وتحييد الهيمنة غير المشروعة.
.............................................
الآراء الواردة في المقالات والتقارير والدراسات تعبر عن رأي كتابها
*مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية / 2001 – 2025 Ⓒ
http://mcsr.net
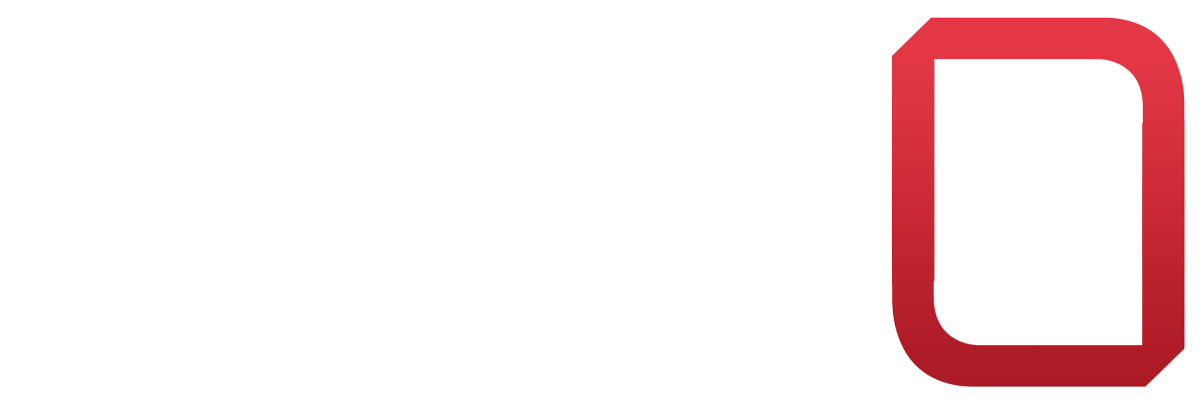
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!